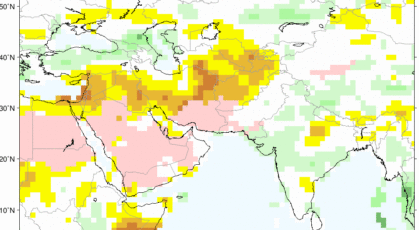بقلم نصر الدين بن حديد – باحث الجزائري :
المتابع لما هي نقاشات بيزنطية مشوبة دائما بالعنف اللفظي، بين أنصار (ما يُسمّى) «الربيع العربي» من جهة، مقابل من يرونه «ربيعًا عبريّا»، يلاحظ أنّ الطرف الأوّل يدافع عن «دولة الديمقراطيّة» وإن اعتراها ضعف أو اتسمت بالوهن وضعف السلطة المركزيّة، ممّا هدّد ولا يزال استقرار الدولة، إن لم نقل وجودها، من ناحية، مقابل دفاع الطرف الثاني عن «دولة الاستقرار» وإن اعترى هذا المشروع عديد التعديّات على حقوق الانسان وما هي «كرامة الفرد» في أبعادها الأخلاقيّة المحليّة أو الكونيّة الانسانيّة.
الطرفان على اتفاق تام بشأن نقطتين:
أوّلا: استحالة قيام «المشروع» دون دفع هذه «الضريبة»،
ثانيا: صعوبة أو استحالة الجمع بين الرؤيتين ضمن مشروع جامع.
من ذلك تتخذ النقاشات البيزنطية بينهما بُعدًا «هجوميا» بحتًا، أيّ «فضح» الطرف المقابل، بطريقة تجعل كلّ من المشروعين يرتقي بالمقارنة وليس بذاته، ممّا يعني الاعتراف ـ وإن كان ضمنيا ـ بوجوب دفع هذه «الضريبة» ومن ثمّة تأجيل أو إلغاء البحث في «مسألة الاستقرار» بالنسبة للطرف الأوّل، وأيضًا «مسألة الديمقراطيّة» بالنسبة للطرف الثاني.
قراءة لما هو المشهد الماثل أمامنا راهنًا، يمكن الجزم أنّ الطرف الأوّل [أنصار «الربيع العربي»] يعانون من تراجع مشروعهم في جميع الدول التي مسّها هذا «الربيع» بطرق متفاوتة، ممّا جعلهم في تراوح بين «الدفاع عن المشروع» من ناحية، مقابل التنظير لوجوب استمرار «المقاومة» المتراوحة بين السلميّة في كلّ من مصر وتونس والمسلحة في كلّ من ليبيا وسورية. الطرف المدافع عن «دولة الاستقرار» يرى في العودة إلى صدارة المشهد، دليلا لا يقبل الدحض على أنّ «الربيع العربي» لم يكن سوى مجرّد قوس تمّ اغلاقه أو هو بصدد فعله، دون استخلاص العبرة أو القيام بقراءة جديّة للأسباب التي دفعت من خرجوا على النظام، وأحيانًا مارسوا العنف في شدّة فاقت عنف النظام أحيانًا…
تأصّل هذا الصراع بين الطرفين، في صورة «جبهة القتال» الأهمّ، ضمن الدول المعنيّة بهذا «الربيع» بل تجاوز كلّ أشكال الصراع الأخرى، ممّا يعني (وهنا الخطورة) تأبيدًا للصراع ضمن هذا المنحى، وكذلك تجاوز أشكال الصراع الأخرى أو اعتبارها جزءا من هذه المعركيّة الوجوديّة بين «دولة الديمقراطيّة» مقابل «دولة الاستقرار».
خطورة هذا الصراع، أنّه يتجاوز بمعنى التقليل من الأهميّة أو هو النفي للمطالب الأصليّة التي بها ومن أجلها انفجر هذا «الربيع» في جميع هذه البلدان، أيّ تلك «الوصفة» الجامعة لمطالب اجتماعيّة واقتصاديّة، معطوف عليها مطالب أخرى تخصّ الحريّات والديمقراطيّة، مختصَرة في معنى «الكرامة» المرفوعة في جميع الدول دون استثناء.
خروج الجماهير في الجزائر بتاريخ 22 فيفري/شباط 2019، أدخل البلاد وفق أغلبية الآراء ضمن دائرة «الربيع العربي»، وإن كان «الموجة الثانية» كما نظّر البعض، من باب المقارنة والقياس، إن لم نقل الانخراط والمواصلة، ممّا يعني فتح ملف جديد ضمن دائرة النقاش البيزنطي بين طرفي الصراع، لتختلف (كما هي العادة) القراءة، بين مُطالب بالذهاب والمواصلة على درب الحريّة والديمقراطيّة وما يعني ذلك من إلغاء وتفكيك لمنظومة الدولة القائمة ـ افتراضًا في الجزائر، من ناحية، مقابل من يؤمن أنّ هذا الربيع مجرّد «مؤامرة» مسقطة من الخارج، معربين عن خشية من أن يكون مصير الجزائر أشبه بمصير ليبيا ومصر أو تونس في أفضل الحالات.
منذ اللحظة الأولى تبيّن بالكاشف ودون حاجة للتعمّق أنّ المعادلة في الجزائر غير معنيّة بصفة مباشرة بما هي «جبهة القتال» بين أنصار «دولة الديمقراطيّة» مقابل «دولة الاستقرار»، حين تأكد أنّ الرهان في الجزائر لا يعني «اسقاط الدولة» وإن رفعت الجماهير على مرّ الأسابيع شعار «اسقاط النظام» دون تقديم مدلول فعلي على مستوى التطبيق السياسي لهذا الشعار.
رجوعًا إلى جميع حالات «الربيع العربي» يمكن ملاحظة أنّ الجماهير ثارت ضدّ «أجهزة الدولة المسلحة»، جميعها أو بعضها، وأنّ هذه الأجهزة شكّلت جميعها أو بعضها مجرّد أدوات قمع في يد الدولة، ومن ثمّة جاء وكان موقف النفي منها، على اعتبارها جزءا من القمع ومن ثمّة من الأزمة ولا يمكن أن تكون جزءا من الحلّ المطروح من قبل أنصار «دولة الديمقراطيّة»…
لم تمارس قوّات الأمن في الجزائر ولم ينخرط الجيش في أيّ عمليات قمع، ممّا أفهم الجميع أنّ هذه الأسلاك المسلحة، لا تخضع لقرار السلطة السياسيّة، وكذلك غير معنيّة بما هو هوس هذه السلطة وغيرها من السلطات المرتبطة بفكرة «دولة الاستقرار» بمسألة «تأمين الأمن» مهما كان الثمن، أيّ بعبارة أخرى الذهاب في عمليات قمع هدفها انقاذ النظام قبل التفكير في مسألة «الأمن» ضمن أيّ معنى من معانيه.
سلميّة المظاهرات في الجزائر وما قابله من «سلميّة» قوى الأمن وجلوس الجيش على الربوة أوّل الأمر ثمّ نزوعه نحو اتخاذ مواقف مساندة للحراك الشعبي ومن بعدها مدافعة عنه وضامنة لحقوقه، يجعل الصورة النمطيّة الراسخة عمّا هو «الربيع العربي» غير متوافقة مع «الواقع الجزائري»، بدءا من شعار «الجيش والشعب خاوه خاوه» [أي أخوة]، نهاية إلى رفض التدخّل الخارجي على اعتبار أنّ ما يجري في البلاد «مسألة عائليّة»، تعيد طرح ما يتفقّ بشأنه طرفا المعادلة من نفي متبادل بين كلّ من «دولة الديمقراطيّة» مقابل «دولة الاستقرار»…
لا أحد في الجزائر راهنًا يعتبر «قوّة المؤسّسة الأمنيّة» عامل تهديد مباشر وخطير للحراك الشعبي أو ينظر إلى المؤسّسة العسكريّة، طرفا غير مساند لهذا الحراك، بل يأتي تأكيد أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع وقائد الأركان على وجوب تفعيل المادتين السابعة والثامنة إضافة إلى المادة الثانية بعد المائة، موقفًا متقدّما على جميع الأطراف، خاصّة السياسيّة والمعارضات على وجه الخصوص، علمًا وأنّ هذه المؤسّسة ترفد الفعل بالقول، بدءا بتشبيه دوائر الرئيس بما هي «العصابة»، ممّا دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إعلان الاستقالة.
تبدو في الجزائر ارهاصات مصالحة (بمعنى التأسيس الفعلي والفاعل) بين طرفي التناقض الماثل على مدى حالات الربيع العربي الأخرى، بين «دولة الديمقراطيّة» و«دولة الاستقرار»، حين طالب العمق الشعبي بالجمع بين الاثنين وكذلك جاءت مواقف الجيش الذي يستند إلى المادة 24 من الدستور، ضامنة للمطلبين، أيّ بناء على دور الجيش في حماية الوطن والذود عن حماه.
لا تزال المعادلة في الجزائر قابلة للتطوّر للذهاب نحو مخاض قد يطول إلى حين التأسيس لدولة تجمع طرفي الصراع بشأن الربيع العربي، أيّ دولة تكون في الآن ذاته «ديمقراطيّة» كما هي «مستقرّة»، بمعنى جيش قويّ وجهاز أمن فاعل، ممّا يستوجب (فلسفيا على الأقل) إعادة قراءة المشهد العربي في علاقة بما هو «الربيع العربي» وفق منظار جديد وزاوية أخرى، أساسها التساؤل عن أسباب الانتقال من «دولة مستقرّة» بفعل البوليس وعصا الظلم وجبروت أجهزة لا مكان في قاموسها لمفاهيم الحريّة وحقوق الانسان، إلى «دولة ديمقراطيّة» عبّر «ثوارها» منذ اللحظة الأولى أو عملوا أو هم حملوا السلاح، من أجل تدمير الدولة بكاملها وأساسًا التخلّص من المنظومتين العسكريّة والأمنية، بل هي التصفية والاجتثاث، دون ترك أثر…
دون السقوط في قراءات عاطفيّة أو مبنيّة على تغليب طرف على طرف أخر، يكون السؤال عن الأسباب التي دفعت «الثوار» إلى الرضا والقناعة بل المطالبة والعمل على تأسيس «الديمقراطيّة» على أساس خراب الدولة وتدمير أجهزتها، ومن ثمّة هل يجوز الحديث [من منظور علمي وأكاديمي حصرًا] عن المعنى المعتمد لما هي «ديمقراطية»؟
كذلك، يبدو جليا أنّ «دولة الاستقرار» وقد عادت إلى السيطرة بدرجات متفاوتة على سدّة الحكم في الدول التي مسّها هذا الربيع، غير معنيّة بالقيام بأي «نقد ذاتي» بل نرى أنّ هذه العودة إلى الحكم أعقبتها «أصوليّة جديدة» تؤكّد على أنّ «الديمقراطيّة» شرّ ومدخلها شرّ، وأنّ الحلّ يكمن في أن يواصل «قطار الإستقرار» مساره وفق كان قبل «الحراك الثوري»…
انعدام ثقافة «النقد الذاتي» والنزوع نحو الظهور في صورة «طهرانيّة» مطلقة، واعتبار أنّ مجرّد التفكير في «التطبيع» مع الطرف المقابل «خيانة»، حتى في دولة مثل تونس [الحالة الأفضل أو الأقلّ سوءا ضمن أمثلة «الربيع العربي»]، قام «توافق» بين كلّ من حركة «النهضة» المحسوبة افتراضًا [عند مغادرة بن علي السلطة] على «الثورة»، بحكم أنّها عارضت زين العابدين بن علي ونالها من بطشه الكثير، من ناحية بمعيّة حركة «نداء تونس»، الوريث المباشر والأقوى للحزب الواحد والأقوى زمن بن علي والمسنود من قبل «الدولة العميقة»، شكّل لفترة غير هيّنة أساس «الاستقرار» السياسي في البلاد.
لم يكن هذا «التوافق» محلّ رضا وقبول وتزكية من العمق الشعبي لكلّ من الحركتين، حين كانت قواعد هذا وذاك، تعادي الطرف الأخر، ممّا يعني أنّ «التوافق» شكّل حركة فوقيّة [مهما كان الموقف منه] لا يمكن التأسيس عليها لكسر «جبهة الصراع» بين الفريقين، أي «دولة الديمقراطيّة» مقابل «دولة الاستقرار»، وأقلّ من ذلك التأسيس لمصالحة تاريخيّة، علمًا وأنّ مسار «العدالة الانتقاليّة» في تونس، ممثلا في «هيئة الحقيقة والكرامة» لم يبلغ مداه المنشود، بل يتمّ تعويضه بمشروع قانون من قبل رئاسة الحكومة يقايض التعويض بالتنازل عن تتبّع المذنبين.
يشترك طرفا الصراع، في اعتبار الذات «حتميّة تاريخيّة» لا يمكن الحياد عنها، وأنّ «الكبوات» المسجّلة ضمن المسار، سواء اندلاع «الأحداث» في أيّ قطر أو سقوط رأس النظام، لم يكن سوى ذلك «الفاصل الزمني» الذي يتمّ اصلاحه، بالنسبة لأنصار ما يسمّى «دولة الاستقرار»، مقابل إيمان أنصار «دولة الديمقراطيّة» بأنّ «الفجر آت وإن طال الليل»…
لفهم دوافع كلّ من الطرفين في الدفاع المستميت عن الذات، واعتبار «نقد الذات» ترفًا معرفيّا أو دون جدوى أو هي مجرّد شعارات لا تصلح خارج المؤتمرات ذات الطابع الأكاديمي أو معاهد الأبحاث والدراسات، يمكن الجزم بوجود خلط «مرضي» بين مفهومين: مفهوم «البديل» مقابل مفهوم «النقيض».
فكرة رائجة ضمن الفضاء العربي، أو بالأحرى المعني بالربيع العربي، تقول بل تؤكّد على أنّ من أسقط «نظامًا شريرًا» وحلّ محلّه هو بالتأكيد ودون أدنى شكّ من «الأخيار» بالضرورة، ومن ثمّة اتجهت الأنظار بل انحصر الاهتمام بما يمكن أن نسميه «المستوى الأخلاقي والوطني» للنظام شديد التدني، وثانيا أنّ من يستطيع إسقاط هذا النظام والحلول مكانه هو صاحب «مستوى أخلاقي ووطني» رفيع، وبالتالي صاحب شرعيّة (سواء سياسية وحتّى دينيّة) للجلوس على سدّة الحكم.
هذا الخلط بين كلّ من «البديل» مقابل «النقيض»، بمعنى أنّ «الصراع المادي» من أجل السلطة هو المحدّد لطبيعة النظام الوارث للوضع السابق، وليس (وهنا الخطورة) صراع مفاهيم في أبعادها الفكريّة بالمعنى الفلسفي وحتّى الأخلاقي، يجعل أو هو يعيد الصراع إلى بعد قَبلي (نسبة إلى القبيلة) يجعل السيطرة سابقة للشرعيّة في الحالتين.
الثابت الوحيد ضمن المشهد القائم منذ يوم 17 ديسمبر/كانون الأوّل 2010 يكمن في حقيقة تردّي الأوضاع في الدول المعنيّة بالربيع العربي، سواء على المستويين الاقتصادي والاقتصادي أوّلا، وثانيا غياب الحريّات في بعض البلدان أو هو التسيّب في بلدان أخرى، بفعل لوبيات المال، التي استطاعت في أغلبها الانتقال بين ضفتي الصراع دون عناء.