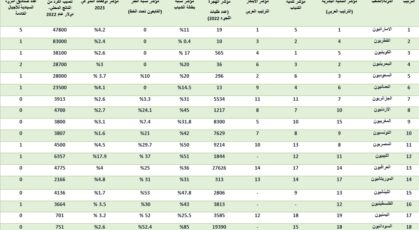قسم أبحاث المركز (MenaCC)
تقرير
ملخص التقرير : لعل تجربة “الربيع العربي” وما عاصرها من تداعيات غير مسبوقة كانت أفضل اختبار، بعد الغزو العراقي للكويت، لمتانة التقارب السياسي بين الدول الخليجية. فقد بينت الدراسات أن الحراك الشعبي الذي شهدته أكثر من دولة عربية والذي رفع مطالب عفوية لحظية غير مدروسة وغير منظمة بدون زعامة، أسهم بشكل غير مباشر في تقارب الرؤى السياسية المشتركة بين الأنظمة الخليجية للحفاظ على استقرارها على المدى القريب والبعيد.
وعلى عكس ما تروج له بعض التقارير من أن الربيع العربي خلّف انقساماً بين دول الخليج خصوصا على مستوى الاستجابة لمطالب التغيير والإصلاح التي رفعها خليجيون مستلهمون من نظرائهم في دول الربع العربي، فان التقارب على مستوى الرؤى بعيدة الأمد والمصالح المشتركة مستمر، لكن بقي الاختلاف الوحيد بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي أججته تداعيات الربيع العربي يكمن في إدارة شكل التغيير خليجيا وعربيا، متحولا الى تنافس بفعل تنامي الثروات النفطية على زعامة الخليج والعالم العربي ومن يؤثر أكثر من الآخر الى أن تحول مع ازمة العلاقات الخليجية الأخيرة الى أزمة استقطاب ومحاور فقط على الزعامة وقيادة محاور في العالم العربي.
لذلك فان الأزمة الخليجية في فحواها تحمل بعدا جزئيا ومحدودا مرتبطا بالداخل بينما البعد الأكبر متربط بالتنافس على التأثير في العالم العربي وفرض مسارات بعينها من خلال دعم طرف دون آخر.
وقد تبين مستوى التقارب الكبير بين الدول الخليج ابان تجربة التعامل مع تداعيات الحراك الشعبي الخليجي المحدود المطالب بالتغيير أسوة بباقي شعوب دول “الربيع العربي”. وقد سعت حينها دول مجلس التعاون الخليجي منذ انطلاق الربيع العربي في 2011 إلى الحد من التظاهر والمسيرات الاحتجاجية التي تستقطب خصوصاً الشباب الخليجيين. وحملت الحركات الشبابية التي شهدت زخما بشكل مضطرد في بداية أحداث الربيع العربي في عام 2011 تداعيات مهمة بشأن مدى التغيير المحتمل في الخليج. حيث سعى الحراك الشبابي الخليجي الى انتهاج مسار الحراك الشعبوي في باقي دول الربيع العربي والذي حمل شعارات تدعو الى قيم واهداف وطموحات متضاربة ومتناقضة وبعضها يدعو الى هدم الحاضر من اجل بناء المستقبل وهو ما وصف بالحراك الداعي للفوضى والذي واجه رفضا منذ البداية من الأنظمة الخليجية التي ترنو الى التفاعل مع المطالب السلمية المكرسة للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وكأقرانهم في الدول العربية الأخرى، يميل الشباب الخليجي الناشط إلى متابعة الأجندة السياسية الأوسع نطاقاً من تلك التي تقدمها عناصر المعارضة التقليدية والأجيال الأكبر سناً. إذ ينادون بإجراء إصلاحات سياسية وتشريعية وقضائية وغيرها من الإصلاحات الهيكلية بدلاً من القيام بثورة شاملة[1]. وباتت حينها مطالب تعزيز المشاركة السياسية وحرية التعبير وانتقاد السلطة تتعامل معها الأنظمة في التجمع الخليجي كمصدر قلق مباشر. وتعاملت معها أمنياً أكثر منها سياسياً بزيادة الملاحقات القضائية وإعادة النظر في هامش الحريات، خصوصاً في الدول التي استجابت أنظمتها في البداية لمطالب التغيير السياسي التي برزت في شعارات المحتجين.
وكانت المسيرات الاحتجاجية العارمة للمعارضة السياسية في بعض الدول الخليجية، مثل الكويت والبحرين، قد مثلت مصدر قلق لبقية الدول الخليجية الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون، التي تحسبت من تداعيات التظاهر من أجل الإصلاح السياسي. فعلى سبيل المثال في الكويت خرجت احتجاجات في عام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية بلغت إلى سقف المطالبة بالوصول إلى حكومة شعبية[2] ينتخب رئيسها من الشعب، فضلاً عن انتقاد السلطة.
وانتقدت السلطات الخليجية مطالب المعارضة السياسية التي انسجمت الى حد ما مع مطالب ثورات شعوب دول عربية أخرى تختلف معها في المنظومة والبيئة والقوانين، والمتمثلة أبرزها في توسيع المشاركة الشعبية في السلطة، واحترام حقوق الانسان[3].
وتفاوتت ردّة فعل السلطة في الأنظمة الخليجية على المطالب التحررية التي رفعها المحتجون في 2011، إلا أن القاسم المشترك بين كل دول الخليج تمثل في إعلان مزايا وعطايا مادية جديدة للمواطنين، وهي استراتيجية تقليدية للتعامل مع أي اضطرابات شعبية محتملة، أكانت عن طريق رفع الرواتب أو المنح أو توفير أعمال جديدة في القطاع العام، وفُعّلت هذه الاستراتيجية في كل دول المجلس بلا استثناء[4]. واستمر الخلل السياسي في دول الخليج في ظل ضعف المُشاركة السّياسيّة الشّعبيّة الفعّالة ودورها في تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة في أغلب دول المنطقة، وهو الأمر الذي أدى إلى استمرار الخلل في علاقة السّلطة بالمجتمع[5]. الا ان الحكومات الخليجية سرعان ما قامت ببعض الإجراءات لتدارك عملية الإصلاح وتعزيز المشاركة الشعبية السياسية كالسماح بالانتخاب الجزئي في المجالس التشريعية أو المحلية، بعد أن كانت تتم بالتعيين في أغلب دول الخليج. ومنذ عام 2011 أنجزت دول خليجية كثيرة إصلاحات سياسية لكن وتيرتها تبقى بطيئة خصوصا على مستوى تفعيل القرار والانجاز.
بالإضافة إلى ذلك، فلقد لعبت استراتيجية القوة الأمنية في التعامل مع المتظاهرين في 2011 دوراً محدودا، وإن تفاوتت حدتها بين دول المجلس. بينما غلب الطابع السلمي على أغلب الحراك السياسي الخليجي آنذاك. وعمدت أغلب الدول الخليجية الى إدارة سلمية للمطالب الإصلاحية[6]. وعلى الرغم من أن البحرين أجرت تعديلات دستورية أيضاً، إلا أنها إجمالاً تمّ رفضها من قبل المعارضة واتهامها بأنها شكلية وبلا أي مغزى، على عكس الحال في عمان. ويرى بعض المراقبين أن السعودية كذلك استطاعت القيام بحركة إصلاحية استجابة لتداعيات “الربيع العربي” من خلال زيادة تفعيل المحاسبة والشفافية وتعزيز المشاركة السياسية، بما فيها دخول المرأة إلى مجلس الشورى والانفتاح النسبي الإعلامي. أما في الكويت، فقد أدت الضغوطات السياسية إلى تغيير رئيس مجلس الوزراء وحُلّ المجلس النيابي أكثر من مرة، ولكن مازالت تبعات هذه الهزات السياسية من الناحية الدستورية والقانونية غير واضحة[7]. وكذلك استطاعت السلطة التشريعية والتنفيذية في الكويت تمرير قوانين مؤسسات ترعى مكاسب حقوق الانسان على غرار إقرار الديوان الوطني لحقوق الانسان. ويعتبر مؤشر تغيير إيجابي لصالح تكريس الممارسة الديمقراطية.
وترتبط الحاجة إلى التغيير والقدرة عليه بعاملين: عامل موضوعي يتمثل في وصول الاجتماع السياسي إلى حدود الأزمة، وانقطاع عملية التواصل بين النظام السياسي والجماهير، وعامل ذاتي يتثمل في إدراك الجماهير لقيمتها الحقيقية كمؤثرين في استقرار النظام أو تغييره[8]. وقد أسهمت الأنظمة الخليجية عبر تعزيز سياسات التوعية والتحسيس والاعلام في نبذ أفكار التغيير الفوضوي وغير المدروس والتطرف وتعزيز الاصطفاف في مشروع الوحدة الوطنية.
وقد استغلت دول مجلس التعاون الحاضنة القبلية لرفض الشعارات التي تحث على التغيير الفوضوي، والظاهر أن التجذر القبلي، العشائري، المذهبي أو الطائفي في أنسجة المجتمعات العربية بدأ يكشف عن كثير من رموزه في عدد من الساحات المنتفضة من خلال ما يملكه من إمكانيات هائلة على تجديد مقوماته[9].
ومازالت دول الخليج تعاني من إضعاف لدور المجتمع الأهلي وتهميش لأدوار التيار السياسي أو النقابات أو الصحافة برغم من أنّ المعطى القبلي بدأ يتقلص وازدادت نسبة التعلّم وقدرة المواطن على الانخراط بحسّ سياسي واعٍ في إدارة الصالح العام. ولكن عدم وجود إطار قانوني ودعم جديّ من الحكومات الخليجية يعرقل تفعيل الدور المهم للمجتمع الأهلي في بناء التطوّر السياسي رغم توّفر الكفاءات والموارد البشرية والمادية، بالإضافة إلى المبادرات التي من شأنها أن تساهم في انخراط فعّال للمواطن داخل الشأن العام.
وفي ذات السياق يجب على الحكومات الخليجية أن تدعم حيويّة المجتمع الأهلي باعتباره ضامناً لفعالية وشفافية مشاريع بناء الدولة ومهمته الأساسية تقريب الدولة إلى مصالح الناس وهمومهم الحقيقية بعيداً عن تمركز السلطة في أيدي أشخاص متنفذّة. وبالتالي، فتوّجه الدولة نحو تمكين وتقوية مختلف الفاعلين في المجتمع المدني يضفي حيوية داخل المجتمع ويزيد ثقة المواطن في صناع القرار[10]. وبدت سياسات الأنظمة الخليجية في دحض فكرة التغيير الثوري متقاربة أكثر من أي وقت مضى.
فقد كشفت أزمة العلاقات بين كل من قطر من جهة، والسعودية والبحرين والامارات من جهة أخرى، وجود نزاع خفي لا على مستوى الاختلاف حول الأنظمة الداخلية او التغيير الداخلي بل على مستوى الرؤى المشتركة لإدارة مسارات التغيير الخارجي في محيطها العربي وتصريف الأزمات وإدارة السياسات الخارجية ومفهوم الدولة الحديثة وتوصيف كيان التعاون الخليجي. وفي الوقت نفسه بقيت متقاربة جدا على مستوى توصيف النظام الداخلي وآلية عمله وعلاقة النظام بالمجتمع.
كما أن العضوية في الكيان الخليجي لم تقدم للدول الأعضاء تعريفا عمليا كافيا عن كيفية ادارة استقلالية التوجه السياسي لكل دولة خليجية وتأثيره على استقرار البيت الخليجي. ونتيجة ذلك بقيت منظومة الاستتباع مقابل غياب تنسيق في الرؤى هي من تعيق مبدأ التكامل بين دول الخليج، حيث وان توافقت عدد من الدول الخليجية على بقاء الكيان الخليجي موحدا في مواجهة التهديدات المحدقة، ترفض في المقابل بعض الدول الاخرى أن تكون تابعة لتوجهات وخيارات سياسية مفروضة بحجة التوحد امام التهديدات الخارجية.
وان أسهم الحراك الجماهيري في دول الخليج في فترة الثورات العربية الى تقارب وقتي بين الأنظمة لتأمين استقرارها، الا انه لم يرتقي للتهديد الوجودي الذي يفرض على الدول الخليجية التوحد الشامل في ظل منظومة مجلس التعاون، حيث مثَل تعريف “الربيع العربي” خليجيا السبب نفسه لتعمق الخلاف في ادارة الحلول لمعالجة تداعيات الحراك الجماهيري وللاستجابة لمطالبات الإصلاح. وبلغ الأمر الى اختلاف بعض الدول الخليجية حول تجريم بعض التيارات السياسية بعينها، وعاد الخلاف الحقيقي الى المربع الأول المتمثل في الصراع الخفي بين الدول الأعضاء حول آليات استبدال منظومة الاستتباع بالتكامل. هذه المنظومة التي تتشبث بها دول، وترفضها دول أخرى مختلفة بينها على توصيف الخطر الايراني وطريقة التعامل معه على سبيل المثال. وبالتالي ساد مبدأ الاستقطاب بدل التكامل بين الدول الاعضاء.
الا ان هذا الاختلاف حول تقبل منظومة الاستتباع وإدارة التغيير والتأثير في العالم العربي والمنطقة وان مثل أساس الازمة الخليجية غير المباشر، الا انه لا يرتقي ليكون سببا مزعزعا لكيان مجلس التعاون الخليجي. حيث ان جل الأنظمة متشابهة في المعايير الأساسية للسلطة والعلاقة مع الشعب. وفي ظل عدم وجود خلاف داخلي جوهري حالي فان أي خلافات أخرى حتى وان بلغت ازمة قطع العلاقات لن تكون مزمنة ويمكن حلها في ظل التشابه الكبير في أسس أنظمة الحكم والتي تسهل أي تسوية للنزاعات. لكن يبقى التدخل الخارجي من يؤثر سلبا لاستمرار الأزمة بين دول الخليج.